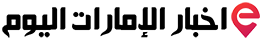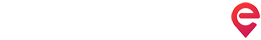الجنازة الأولى
كان طريقي الوحيد من مكان نزوحي إلى مكان نزوحي الثاني يمر عبر مقبرة واسعة ممتلئة بالقبور، كنت أسير وسطها في طريق رسمته أرجلُ المشاة بين القبور، كانت جماهير المشيعين تتكوم حول القبور في انتظار إتمام طقوس الدفن، انقطعت كل الاتصالات منذ أربعة أيام، لم نعد نعرف أسماء الشهداء، والأهم لم نعد نعرف حال بقية أهلنا المشتتين في أماكن النزوح، هل هم من المصابين والشهداء، أم هم من الناجين؟ لذلك لا بد أن نذهب لرؤيتهم يومياً لنطمئن عليهم. كانت أكوامُ المشيعين في صباح هذا اليوم تتحلق حول ثلاثة قبور في المقبرة التي امتلأت منذ مدة طويلة، كل الذين يدفنون في ساعات الصباح الأولى استشهدوا يوم أمس فقط، غارات القتل والدمار مساء الليلة الفائتة كانت عديدة، لدرجة أن عدد الذين استشهدوا في هذا اليوم وفق تقدير الإذاعات المسموعة بلغ سبع عشرة ضحية جرى انتشالها في ساعات الصباح الأولى، وهناك مفقودون من الأطفال والنساء ما يزالون تحت الركام.
محظوظون هم الذين لهم أهل أو أقارب كي يتولّوا دفنهم!
عندما زرتُ مستشفى الأقصى قبل يومين رأيتُ خيمة واسعة داخل ساحة المستشفى مملوءة بجثث الشهداء لأن ثلاجة الموتى تكتظ بأجساد كثيرين ممن لم تعرف أسماؤهم، أو ممن استشهد كل أفراد عائلاتهم ولم يبق لهم مَن يتعرفون عليهم وينقلونهم للمقبرة المكتظة بالجثث إما محمولين على الأكتاف أو على عربات الأحصنة والحمير، ومن ثم يحفرون لهم القبور، محظوظون مّن يظفرون بقبرٍ في المكان المكتظ بجثث الشهداء!
ما أكثر الذين لا يجدون لهم قريبا أو صديقا يكمل مهمة الدفن، هناك عائلات بكاملها استشهدت، ولم يبق لهم أحد يشيعهم إلى مثواهم الأخير، بقيت جثثهم في المستشفى، لا تستوعبهم ثلاجة الموتى الصغيرة، لذلك فقد حفر مسؤولو المستشفى مقبرة داخل أسواره ليتمكنوا من أن يواروا كل الذين ليس لهم من يتولى دفنهم.
سمعت وأنا أسير داخل سور المقبرة جدالاً بين أحد المشيعين ومسؤول الدفن، لأن المسؤول يرفض إغلاق قبر أبيه الشهيد بالتراب، قال له: «لن أُغلق القبر قبل أن يدفن معه شهيدان، كل ثلاثة شهداء في قبر واحد» لذلك أبقوا القبور مفتوحة، بغطاء شفيف من الزنك القديم المهترئ.
طأطأت رأسي وأنا أسير بين القبور، أسرعت الخطى، حتى لا يراني أحد معارفي ممن يتولون دفن موتاهم، لأنني سأضطر إلى أن ألتزم بإتمام الطقس كاملا، وبالتالي سوف أتأخر عن الوصول إلى مكان نزوحي الثاني!
سمعتُ المؤبّن يأمر المعزين الواقفين عند أحد القبور بالجلوس عقب إنهاء عملية الدفن، ويقول: إنهم عائلة بريئة اختارهم المولى إلى جواره، هم خمسة شهداء من عائلة واحدة، عاشوا كرماء عفيفين محبوبين من الجيران والأقارب، هم اليوم شهداء، اللهمّ افسح لهم في قبورهم مكانا في الرضوان، اللهمّ أعذهم من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض، اللهمّ املأ قبورهم بالهناء والوفاء، والغبطة، والسّرور.
هكذا استعمل المؤبن صوته الجهوري وبراعته في اللغة ليطفئ نار الفقد عند ذويهم ومعارفهم المتحلقين حول القبر.
سرتُ باحثاً عن وسيلة نقل توصلني إلى مكان نزوحي الثاني، لأن بقية أهلي يسكنون في خيمة بعيدة عن مكان نزوح زوجتي، حاولت أن أجد وسيلة نقل للمكان، لكنني فشلت حتى في إيجاد عربة كارو، اضطررت أن أسير المسافة كلها على قدميَّ وصلت خيمة لجوئي كنتُ منهكا جائعا، لمحت حالة من الوجوم على وجوه أقاربي في الخيمة، قالوا : منذ وقت قصير عرفنا بأن عائلة ابنة أختك، هي وزوجها وثلاثة من أبنائها استشهدوا ليلة أمس ودمر منزلهم بالكامل، وقد جرى دفنهم سريعا، لقد علمنا بالخبر قبل قليل فقط!
فقدتُ توازني بسرعة، انهار جسدي على حصيرة الخيمة، خشيت أن أقول لهم إنني كنت بجوار قبورهم، وكان المؤبن يؤبن عائلة ابنة أختي، وأنا لا أعلم من هم الشهداء!
الجنازة الثانية
كانت تنعم في بيتٍ مكون من ثلاثة طوابق، فيلا فارهة، كان شارعها هادئا نظيفا جميلا، ظلتْ وهي فتاة جميلة تسعى للحصول على الثروة والمال لتجعل أبناءها سعداء منعمين، ولما طار أبناؤها من حُضنها أحست بالكآبة والخوف من الموت، لذلك ظلت تحاول الحصول على نبتة الخلود، نبتة البطل الأسطوري جلجامش، كانت ترى أنها أكملت دورها في الحياة، كانت تحاول أن تجعل من بيتها مزرعة وبيتا جميلا، زرعت سطح البيت بالأشجار والورود، وأنبتت في ساحة البيت الخارجية أشجار الليمون والبرتقال، كانت تجمع في ثنايا غرفة نومها، سريرا وثيرا تفخر بامتلاكه من خشب الزان الفاخر.
اعتادتْ أن ترى علامات الإعجاب بفيلتها الجميلة على وجوه زائريها، كانت تتعمد أن تحضر لهم بعض ثمار حديقتها ليتذوقوا حلاوة البلح والعنب والتين، اعتادت أن تشرح لهم كيفية الحصول على أنواع تينٍ منوعة من شجرة واحدة، وكيف أن في كل فرعٍ من فروع شجرة التين نوعا مختلفا، تين أسود، وآخر حماضي، وثالث تركي، ورابع بحري!
ظلت تفتخر بابنها الذي هاجر إلى أميركا وتزوج هناك وأنجب ابنته، وكانت تطلبه بالهاتف عند أول زائر من الزوار لتُسمع زائريها صوته، وأنه ما يزال يحبها!
هي أيضا تحتفظ في غرفة الجلوس بما يذكرها بمسقط رأس والدها، تحتفظ بثوب أمها المطرز بألوان الورود، وتحتفظ بصورة والدها وهو يحتضنها طفلة صغيرة ضمن أفراد الأسرة!
كانت تشعر بأقصى درجات السعادة وهي تحتفل بزواج ابنتها لأحد الأقارب.
قررت مُكرهة أن تواصل رحلة البحث عن عشبة الخلود، ولكنها فجأة أضحت في غمضة عين نازحة في خيمة إيواءٍ في أقصى جنوب غزة ، تسكن خيمة ليس فيها أبسط مقومات الحياة، خيمة لا تقيها من البرد، بعد أن كان في بيتها ثلاثة أنواع من التدفئة المكيف الكهربي، ومكيفات الكيروسين، بالإضافة إلى مدفئة الحطب!
ظلتْ شهرا كاملا تحلم بأن تعود إلى مسكنها الجميل، كانت تبتسم لكل خبر يشي بقرب الوصول إلى اتفاق يسمح لها أن تعود إلى سرير نومها، وإلى أشجارها، ظلت تبكي كلما سمعت المحيطين بها يرددون لا أمل في العودة، كانت تبكي بصوت عالٍ عندما تقصف طائرات الاحتلال أي منزل في جباليا!
قالت ابنتها: غفت على وقع قصف المدافع والطائرات غفوة سريعة لكنها استيقظت على صوت المذيع في هاتفها الخاص، وكان آخر خبر سمعته في الإذاعة: «دمر المحتلون مربع بيتها السكني بأحزمة نارية» لم نعد نسمع حركتها الدائمة، ظننا أنها غفت غفوة طويلة بعد أن عانت في مساء اليوم الفائت من تعب وإرهاق، رفضت أن تشرب منقوع حبات العدس الصفراء، وكسرة من الخبز المغموس في شوربة العدس.
كنت قريبا جدا من مكان جنازتها، كانت المسافة فقط أقل من عشرة كيلومترات، غير أن المسافات في وطني لا تقاس بالمقاييس الجغرافية المعتادة، بل تقاس بعدد الدبابات وعدد القنابل التي تقصف الأبنية والبيوت والسيارات وعدد الشهداء في هذا اليوم.
كنا نعلم أنها تعاني من أمراض النزوح كما نعاني، غير أنها كانت هي الأسوأ، بخاصة في شهر كانون الثاني وشباط 2024 حيث موجة البرد الشديدة في الخيام.
لم تكن الاتصالات متاحة في ذلك اليوم، خبر وفاتها وصلنا بعد دفنها بعدة ساعات عانت من النزوح والبرد، لم تحتمل فراق فيلتها الفاخرة وفراشها الوثير فاكتأبت، ولم تعد قادرة على الحديث.
كانت هذه الجنازة هي أيضا جنازة أختي التي لم أتمكن من المشاركة فيها!
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية