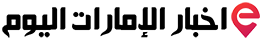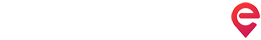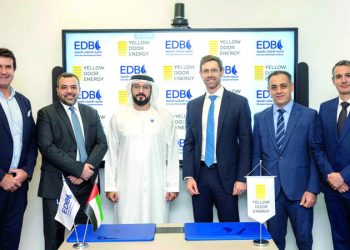شكّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض صدمةً كبيرةً لكثيرين في أوروبا، وفي الشرق الأوسط، وبالطبع للديمقراطيين وغيرهم من النُخَب، خاصّة في الولايات المتحدة. وأثارت عودته، التي يصعب القول إنها غير متوقّعة، صدمةً كبيرةً خاصّة مع ما يحمله في جعبته من مفاجآت للجميع. والمتأمل في مسار الدعاية الانتخابية في آخر شهرَين يمكن له أن يرى عودة ترامب التدريجية إلى المكتب البيضاوي، وباستثناء المناظرة التلفزيونية بينهما، فإن أداء منافسته كامالا هاريس كان أسوأ من أن تكون رئيسةً، خاصّةً تردّدها في اتخاذ موقف حاسم في قضايا كثيرة، حتى بدت صدى صوتٍ مبحوح لبايدن العجوز. في المقابل، نجح ترامب، الذي قاتل بكلّ السبل من أجل العودة، في كسب الجميع، حتى الصوت العربي والإسلامي الذي أصرّت هاريس على خذلانه.
وفيما يمكن استشعار القلق بشكل واضح، وإدراك مدى ما تشكّله تلك العودة من أخطار على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع، تظلّ الأزمة فينا وليست في ترامب. ولكلّ الذين يصرّون على المفاضلة بين رئيس ورئيس في واشنطن، عليهم فقط أن يقرأوا تاريخ السياسة الأميركية الذي يصعب فيه أن تجد فروقاً جوهريةً في مواقف الرؤساء، إلّا على صعيد توظيف مواقفهم والتعبير عنها. ويمكن للمرء بيقين أن يستدلّ على غياب تلك الفروق في ظلّ الإدارة العميقة التي تتحكّم بالسياسة الأميركية، تاركةً مساحةً للرئيس فقط في لبس القناع الذي يريد، من أجل أن يمارس دوره ويقوم بوظيفته من دون أن يتجاوز الخطوط العامّة والحمراء. مثلاً، هل تراجع بايدن عن مواقف ترامب التي اتخذها بخصوص القضية الفلسطينية مثل نقل السفارة إلى القدس أو تأييد الضمّ، وغير ذلك؟ … لو قدّر لترامب أن يفوز بولاية ثانية مباشرةً بعد ولايته الأولى، وهزم بايدن وقتها، لم يكن ليفعل أكثر ممّا فعل بايدن من مواصلة تأكيد وتثبيت القرارات التي اتخذها في فترة ولايته الأولى. لم يقم بايدن بأيّ موقف يمكن أن يُحمَد عليه، ويمكن استذكاره به والترحّم على زمنه. بالعكس، فإن أبشع المذابح في تاريخ البشرية (ربّما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد النكبة ) تمّت في عهده، وبصمت معيب منه.
من يتوقّع أن يتراجع ترامب عن مواقفه السابقة أيضاً مخطئ، كذلك من يتوقّع منه مواقف أكثر إنصافاً للفلسطينيين، لأن طبيعة الرجل لا تعتمد على التطوّر المنهجي للوعي، بل على التصرّفات العشوائية المفاجئة. لكنه في هذه المرّة يأتي إلى البيت الأبيض وقد قرّر قبل دخوله أن يسلّح نفسه بزمرة من غلاة المعادين للحقوق الفلسطينية، وفيما لا يبدو هذا مريحاً للفلسطينيين، فإنه يعكس حقيقة أن لدى الرجل أيضاً إدارة عميقة غير التي تتحكّم بشكل مستمرّ بالسياسة الخارجية الأميركية تجاه القضايا الكُبرى، إدارة عميقة من نوع مختلف قادرة على جعل إسرائيل بوصلة أيّ تصرّف طائش قد يقوم به الرئيس العائد إلى البيت.
التعامل بردّة الفعل على سياسات الاحتلال، وعلى التوجّهات الجديدة لإدارة ترامب، لا يخلق سياسةً قادرةً على الدفع بالمصالح الوطنية والقومية
لا يبدو أيّ شخص من إدارة ترامب القادمة خارج نطاق العداء للحقوق الفلسطينية، وربّما سنجد أنفسنا قد اكتشفنا أن ترامب أقلّهم عدائيةً وأقربهم إلينا، للمفارقة بالطبع. انظروا خطّة سفير ترامب السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي أطلق عليها “الدولة اليهودية الواحدة”، التي يقضي فيها على أيّ أمل لحلّ الدولتَين، ويدعو إلى ضمّ الضفة الغربية، التي لا يعترف بها إلّا بوصفها “يهودا والسامرة”، ويطالب الولايات المتحدة بدعم إنشاء صندوق من أجل تمكين إسرائيل من ذلك. وأقصى ما قد يطمح له الفلسطينيون هو استقلال مدني محدود يخضع للسيطرة الإسرائيلية، فهم لا حقوق جماعية لهم، بل حقوق فردية. وحتى يجنب مشروعه تهمة السعي لتطبيق خطّة قائمة على الفصل العنصري، يقول إن الفلسطينيين سيكونون مقيمين دائمين (على غرار الغرين كارد ربّما)، ولكن من دون حقوق تصويتية، ولا مشاركة في صنع القرار… ليسوا مواطنين. إن “ما منحه الله للشعب اليهودي لا يحقّ لأحد أخذه”، هذه هي خلاصة الكتاب الذي سيكون دليلاً إرشادياً لسياسة ترامب تجاه الصراع.
ساهم أقطاب إدارة ترامب القادمة في التقديم للكتاب، خاصّة وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، وكان استخدم عبارة إعادة لحمة إسرائيل مع إرثها التوراتي المهيب في تبريره خطّة فريدمان الإرشادية، كذلك قدّم للكتاب مايك هاكابي، الذي سيكون سفير ترامب الجديد لدى تلّ أبيب، والمعروف بعدائه الصارخ لفكرة الدولة الفلسطينية، وتأييده المطلق لإسرائيل وللاستيطان. قال مرّة للصحافيين: “هناك كلمات أرفض استخدامها، فلا يوجد شيء اسمه مستوطنات، هناك بلدات ومدن، ولا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، هناك يهودا والسامرة”. كما أن هاكابي يُستفَزّ من فكرة وجود شعب فلسطيني، ويدافع بشراسة عن الإبادة، كذلك مرشّح وزارة الخارجية ماركو روبيو، الذي وبّخ صحافية لأنها انتقدت قتل إسرائيل للأطفال، وكانوا وقتها 15 ألف شهيد، وقال إنه يطلب من إسرائيل القضاء على ” حماس “، لذلك لا بأس في قتل المدنيين، لأن “حماس تحتمي في وسطهم”. هكذا بكلّ سفور يدعم الإبادة ويبرّرها. هذا هو شكل إدارة ترامب القادم والمشكلة ليست في ترامب، بل فينا نحن الذين لم نعدّ العدّة لعودته.
سيظلّ موضوع ضمّ الضفة الغربية قائماً، وسيظلّ الاعتراف الأميركي بالضمّ محتملاً
سيظلّ موضوع ضمّ الضفة الغربية قائماً، وسيظلّ الاعتراف الأميركي بالضمّ محتملاً، وإن كان ترامب سيستخدمه من أجل كسب المزيد من الالتفاف العربي حول سياساته في المنطقة، بمعني أن عدم مصادقته عليه سيحتاج أن تدفع الدول العربية الكُبرى ثمناً يستطيع أن يلجم اليمين المتزمّت في إدارته. وللمفارقة سيكون ترامب مثل بنيامين نتنياهو في حكومته محاطاً بأناس يزعمون أنهم أكثر تطرّفاً منه، ويريد لهم هو (نتنياهو) أن يكونوا كذلك، فيواصل سياساته بلا رادع، ويبدو هو الشخص الوحيد الذي يمكن الحديث معه رغم قيادته للإبادة.
ولكن، مرّة أخرى، هل علينا أن ندفع ثمن كلّ شيء؟ من يعتقد أن إسرائيل غير مؤمنة بأن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، وأنها تتصرّف فعلاً بوصفها قامت بالضمّ وإن لم تعلن عنه؟ … إن التعامل بردّة الفعل على سياسات الاحتلال، وعلى التوجّهات الجديدة لإدارة ترامب، لا يخلق سياسةً قادرةً على الدفع بالمصالح الوطنية والقومية. إن المطلوب هو تطوير سياسات قادرة على مواجهة حالة الاستعصاء في الصراع، والانزياح التدريجي نحو شطب الحقوق الفلسطينية، وليس المطلوب تطوير سياسات للتكيف مع إدارة ترامب الجديدة، ولا محاولة الضغط باتجاه التمسّك بنفس المبادئ السابقة. ثمّة كثير من مفردات السياسة لا بدّ أن تتغيّر. وبقدر تجاوز إدارة ترامب لفكرة الدولتَين (تذكّروا بالنسبة لترامب هذا شيء قديم) بقدر وجوب تجاوزها، وتقديم مقترحات أكثر صلابةً مثل حلّ الدولة الواحدة أو حلّ الدولتَين على أساس قرار التقسيم. الخطاب السياسي العربي ظل طوال العقود الخمسة الماضية أسير توجّه حلّ الدولتَين على أساس الرابع من حزيران (1967)، فيما طوّرت إسرائيل (والعالم) الخطاب تجاه الصراع عشرات المرّات
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية