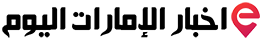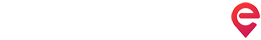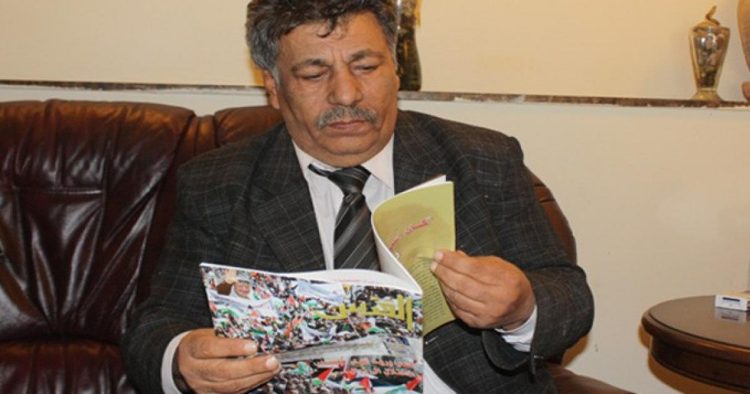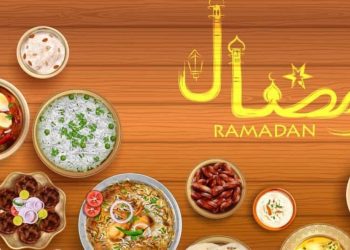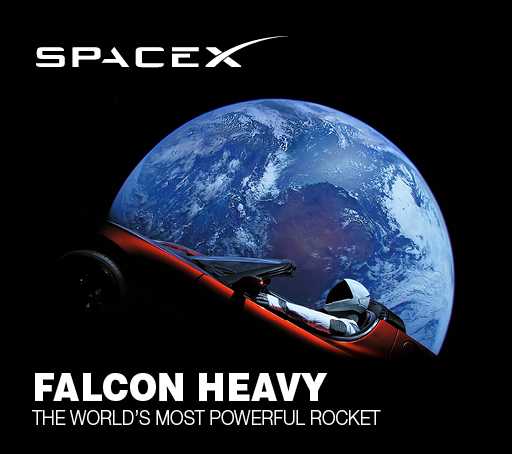في هذا المقال نتابع النقاش مع الأستاذ عبد المجيد حمدان حول ثلاث قضايا رئيسية:
1- استكمال قضية أشكال النضال، وهي قضية تستحق التعمّق والتعميق، وذلك بالنظر إلى راهنيتها المتجدّدة.
2- دور القيادات الوطنية في إستراتيجيات مجابهة المشروع الاستعماري الصهيوني في بلادنا.
3- حول دور «الدين» في هذا المشروع، المسيحي واليهودي، والذي أثاره حمدان في مقاله الأخير، والذي لا يجوز إساءة فهمه، وإنّما فهم أبعاد المسألة الدينية فيه، بصورة تتجاوز المألوف السياسي النمطي لهذا الدور، وبعدم المرور السريع أو المتسرّع على هذه الأبعاد.
استكمالاً للقضية الأولى، واستطراداً لما قلناه في المقال السابق حول أنّ الشعب الفلسطيني لم يلجأ إلى الكفاح المسلّح إلّا لأن المشروع الصهيوني هو الذي فرض عليه هذا التوجّه، وأنّ الكفاح المسلّح عادةً ما كان يلي الأشكال الأخرى، وليس البدء بها، استطراداً لكل هذا نقول:
كان اللجوء إلى الكفاح المسلّح بدءاً من نهايات عشرينيات القرن الماضي، كإرهاصات وكممارسة مباشرة، إذ لا يمكن الحديث حتى عن أيّ إرهاصات جدّية، أو ممارسة عملية للكفاح المسلّح قبل ذلك، كما أوضح حمدان، كان اللجوء إلى الكفاح المسلّح «ينضج» في ضوء تضافر وتكامل عناصر جديدة إلى ساحة المواجهة، وإلى ميدان الصراع المباشر.
وأهمّ هذه العناصر ــ كما أرى ــ كان ازدياد شعور الجماهير الفلسطينية بالخطر على مستقبل البلاد.
تجلّى هذا الشعور بالخطر، وبصورةٍ مباشرة بـ»وعد بلفور»، ثم احتلال القوات البريطانية لفلسطين، وفرض الانتداب عليها، وزيادة معدّلات الهجرة، وبدء اكتساب هذه المعدّلات معالم جديدة من النهج المخطّط له على مستويات سياسية في «الغرب» بالتعاون الوثيق مع أقطاب الحركة الصهيونية، التي كانت في هذه المرحلة قد أنضجت مشروعها المتكامل في صورته الهيكلية الأولى.
أما الدليل الساطع برأينا على أن «انتفاضة البراق» في العام 1929 كانت ردّة فعل على الشعور بالخطر هو أن الهجرة اليهودية كانت قد انخفضت في السنوات (1924، 1925، 1926، 1927) بسبب الاختلافات التي دبّت في صفوف قيادات الحركة الصهيونية آنذاك، وحيث عادت الهجرة في أواخر العام 1928، والنصف الأوّل من العام 1929 إلى أكثر من ضعف معدّلها في العام 1927.
صحيح أن المخطّطات للاستيلاء على الحائط من قبل الجماعات اليهودية، وتجاوز الاتفاقيات غير المكتوبة التي سبقت الاحتلال البريطاني في فلسطين، كانت السبب المباشر للانتفاضة أو «هبّة البراق»، لكن ازدياد معدّلات الهجرة، ومشاركة الاحتلال البريطاني المباشرة في زيادتها هو القاعدة التي ارتكزت عليها تلك الانتفاضة.
ويكاد نفس الأمر يتكرّر في هذا السياق، بوسائل ومقاييس أكبر وأوسع في «ثورة 1936-1939» والتي سنأتي عليها بعد قليل.
ويُستشفّ من المراجع الرصينة، خصوصاً تقرير «لجنة شو»، ومن مؤلّفات إميل توما، بيان نويهض الحوت، د. ماهر الشريف، ناجي علُّوش، وغيرهم العشرات أن أحداث العنف التي عمّت في ضوء «انتفاضة البراق» مدن يافا وحيفا و نابلس وبيسان وصفد، ومهاجمة الأحياء اليهودية فيها أو بالقرب منها، خصوصاً في مدينة القدس ، أن اللجوء المباشر إلى العنف كان مدفوعاً بصورةٍ مباشرة بمخاوف الشعب الفلسطيني على مستقبل بلاده، ومقدّساته، ووسائل عيشه الاقتصادية، وموقف سلطات الاحتلال البريطاني إلى جانب مجموعات اليهود المتطرفة من أتباع زئيف فلاديمير جابوتنسكي، ومن أنصار الاستيلاء اليهودي على المقدّسات اليهودية في المدينة. وبالمناسبة كان موضوع «الهيكل» هو الموضوع الأوّل آنذاك.
أما بالنسبة لـ»الثورة الكبرى 1936-1939»، فقد تحوّل الاستيلاء على الأرض إلى موضوع الثورة، وبرزت التهديدات الاقتصادية للفلسطينيين جليّة من خلال اتساع نطاق الاضطرابات في عموم البلاد بعد أن كانت قد اجتاحت الريف الفلسطيني كلّه، لتمتد إلى المدن، ويتحوّل الإضراب إلى السلاح الأكبر فيها، والذي اصطلح على تسميته «الإضراب الكبير»، والذي اعتبر الأكبر في التاريخ الحديث والمعاصر.
تحوّلت المسألة إلى «الأرض» وتحوّل الاستيلاء الزاحف إلى مقدّمات كبيرة للثورة المسلّحة.
في «ثورة البراق» كانت مسألة الاقتلاع والإحلال والتطهير العرقي ما زالت مجرّد نواة أو جَنين، وفي «الثورة الكبرى»، ومن خلال اتساع نطاق «العمل العبري»، بدأ يتوضّح طريق المشروع الصهيوني الذاهب بسرعة نحو مشروع الاقتلاع والإحلال والاحتلال، فكانت الثورة المسلّحة الردّ التاريخي الأكبر على الخطر الذي بدأت معالمه بالتبلور نحو قيام الكيان الصهيوني على أنقاض شعبنا، وبعد افتضاح الدور البريطاني.
وهكذا فإن أشكال النضال في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني قد تلازمت وترافقت مع عنف المشروع الصهيوني والبريطاني، ومع ازدياد منسوب الخطر والتهديد، ولم يكن شكل النضال في أيّ مرحلةٍ سبقت قيام دولة الاحتلال على أنقاض شعبنا وحقوقنا سوى مداولة بين الأشكال السلمية والعنيفة ارتباطاً بهذين العاملَين بالذات، ولم يكن لدى شعبنا خيارات غير خيار التلازم والمداولة بينهما في الظروف الملموسة لذلك التلازم.
أما فيما يتعلّق بدور الحركة الوطنية، فإنني أتفق مع كامل السياق الذي أورده حمدان، خصوصاً في مسألتين أساسيتين:
الأولى، الطابع التقليدي لهذه القيادات، وميلها «الفطري» نحو المساومات غير المشروعة إلّا في بعض المراحل التي كانت فيها الحركة الشعبية في أوج استعدادها «لتجذير» محتوى المطالبات، ورفع مستوى المجابهات، وإعلاء سقف التطلُّعات.
ولا يعود الأمر في الاستعداد للمساومات غير المشروعة للجذور وللاعتبارات الطبقية والاجتماعية، وإنما يعود الأمر، كما أرى، إلى شبكة العلاقات والمصالح، وإلى نمط الثقافة الأبوية المتأتّية من الطابع التقليدي في الريف الفلسطيني، ومن «ترييف» مراكز المدن الفلسطينية آنذاك، وإلى تركُّز المجابهات في المناطق الداخلية الجبلية، وابتعادها في كثير من مظاهر هذه المجابهات عن مدن الساحل، والمراكز العمّالية الناشئة آنذاك.
وأمّا القيادات الوطنية فكانت متحرّرة نسبياً من النمط العشائري والحمائلي الذي كان يسود في الريف، والتي تعود بأصولها الطبقية والاجتماعية إلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكلت منها بعض القيادات الوطنية والنقابية، لكنها تعرضت لمحاولات متصلة ومتواصلة للتهميش والإبعاد، ووصلت أحياناً إلى حدود الاغتيال كما نعرف.
أهمية وراهنية هذه المسألة بالذات تكمن في واقع الحالة الوطنية. إرهاصات تشكل القيادات الوطنية كانت بُعيد النكبة ، وبعد مرحلة عقدين من زمن الضياع وزمن البحث عن الذات والهوية ــ لنتذكّر هنا رواية غسّان كنفاني «رجال في الشمس»، تشكّلت البدايات الأولى لمبادرة وطنية تاريخية أقدمت عليها حركة «فتح»، ثم تبلورت هذه المبادرة الوطنية بعد هزيمة حزيران 1967، وعبّرت عن نفسها من خلال إستراتيجية جديدة، ليس كمجرّد ردّة فعل على العنف الصهيوني، أو كردّة فعل عن حجم معيّن من الأخطار، وإنما كردّ تاريخي جديد على تمدّد المشروع الصهيوني باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة، وكنهج كفاحي شامل أعقب عدم قدرة الأنظمة العربية التي هُزمت في نكسة 1967 على منع توسّع دائرة هذه المبادرة، وكانت معركة الكرامة 1968، أحد أشكال تجلّي الوضع الجديد، وكان تشكيل منظمة سيناء العربية، وتشكيل منظمة الصاعقة لكي تكون جناحاً مسلّحاً لـ»البعث» السوري، وتكون «جبهة التحرير العربية» جناحاً مسلّحاً لـ»البعث» العراقي، بعد أن تحوّل الجناح الفلسطيني الأردني لحركة القوميين العرب إلى الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وبعدها تحوّلت القوى الثورية الجديدة إلى قوة مجابهة كبيرة في مواجهة المشروع الصهيوني والتوسُّعي لدولة الاحتلال.
قيادة الحركة الوطنية الجديدة بعد عقدين كاملين دخلت في مساومات غير مشروعة على مختلف الصعد. فقد ساومت على نهجها الكفاحي بالتعايش مع الواقع العربي والإقليمي، وحوّلت شعار «عدم التدخُّل»، وشعار «القرار الوطني الفلسطيني المستقل» في مرحلة لاحقة إلى نوع من التعايش مع البرنامج الرسمي للنظام العربي، وتصارعت مع هذا النظام ليس من موقع التنافس الكفاحي ضد دولة الاحتلال، وإنما غالباً من موقع التنافس على تقييد حركة هذه القيادة نحو الانخراط التدريجي في مشروع «الاعتدال» العربي، والذي هو مشروع البحث عن حلّ سياسي بالوصاية الأميركية، وهو الأمر الذي خلق فراغاً قيادياً من زاوية البرامج الكفاحية المتصدّية للمشروع الصهيوني في ثوبه الاستيطاني الجديد، حتى وصلنا إلى البحث عن سلطة ظلّت تتقلّص أهميتها مع تقدم المشروع الاستيطاني على طريق الاقتلاع والإحلال مرّة أخرى، الأمر الذي أدّى إلى ظهور «الإسلام السياسي» برنامجياً، ثم ظهور حركة « حماس » كقطب قيادي جديد. سنستكمل في المقال القادم المخصّص للمناقشات.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية